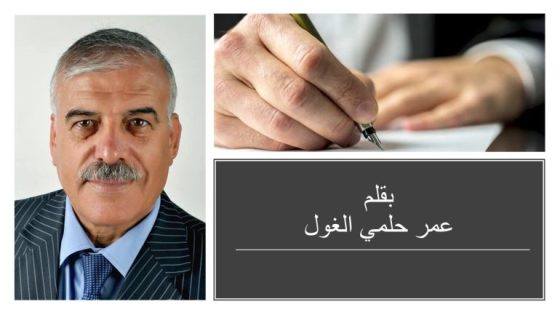بقلم: علي جرادات
لا غرابة في أن تلقي واشنطن بثقلها لانجاح ما سمته «حق إسرائيل» في تولي منصب رئاسة اللجنة القانونية لهيئة الأمم المتحدة، بذريعة تعزيز «اندماج إسرائيل في المجتمع الدولي»، ذلك رغم أن إسرائيل التي تريد واشنطن «اندماجها» هي «إسرائيل الثكنة»، العنصرية، العدوانية، التوسعية، غير محددة الحدود، والمارقة التي لم تنفذ قرارا واحداً من قرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين وتعويضهم، والذي أُعتبر تنفيذه شرطاً من شروط الاعتراف بإسرائيل وعضويتها في الأمم المتحدة. ولا غرابة، أيضا، في أن تصوت دول الاستعمار الأوروبي لمصلحة صنيعتها إسرائيل، وألا تُضيِّع عليها هذا الانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي». ولا غرابة، أيضا وأيضاً، في أن تتجاهل واشنطن والدول الأوروبية احتجاج المجموعة العربية، لنكون أمام حدث غير مسبوق منذ اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، عام 1949، حيث حصلت الأخيرة، (كمرشح لمجموعة منطقة غرب أوروبا وآخرين)، على 109 أصوات من أصل 175 صوتاً صحيحاً في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، مقابل معارضة 47 دولة، علماً أن عدد الدول العربية والإسلامية هو 57 دولة، ما يعني أن ثمة دولاً عربية وإسلامية قد صوتت لمصلحة إسرائيل أو أنها امتنعت عن التصويت.
أجل، لا غرابة، ولا جديد، في كل ما تقدم، فالولايات المتحدة حليف إسرائيل وراعيها الثابت، ومعها صانع إسرائيل، دول الاستعمار الأوروبي، لم تترك فرصة من فرص اختلال النظام الدولي لصالحها إلا واستغتلها لتحقيق أهداف المشروع الصهيوني وترسيمها في المؤسسات الدولية، سواء قبل إنشاء إسرائيل، أو بعد إنشائها. فمن تضمين وعد بلفور بـ»إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» في صك الانتداب البريطاني وترسيمه في «عصبة الأمم» التي تحكمت بريطانيا وفرنسا بالنظام الدولي القائم فيها آنذاك، اتصالاً بانتصارهما في الحرب العالمية الأولى، إلى ترسيم مشروع «قرار التقسيم» البريطاني في هيئة الأمم، عام 1947، إلى تحويل مشروع الاعتراف «الغربي» باسرائيل إلى اعتراف دولي في هيئة الأمم، عام 1949، إلى إلغاء الجمعية العامة لقرارها، عام 1975، اعتبار «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية»، فور حلول نظام «القطب الواحد» وانهيار توازن نظام القوى الدولي في مرحلة «ثنائية القطبية»، وصولاً إلى تولي إسرائيل، بضغط أميركي، وموافقة أوروبية، وتواطؤ أغلب دول العالم، رئاسة أهم لجنة قانونية أممية.
هنا، كان من الطبيعي أن يزهو ممثل إسرائيل، داني دنون، بالقول: «إنني فخور جداً بأن أكون أول إسرائيلي يُنتخب لرئاسة لجنة تابعة للأمم المتحدة، وكرئيس سأعمل مع كل الدول الأعضاء، بما فيها تلك التي لم تصوت لي، وسأواصل دعم الأهداف الحقيقية للمنظمة». بل وكان من البداهة أن يتبجح باستعلاء عنصري، ويقول: «إن إسرائيل في طليعة دول العالم للتشريع الدولي ومكافحة الإرهاب، ويسرنا أن نسمح لبقية دول العالم بالاستفادة من معرفتنا».
أما إعلان المجموعة العربية بأنها «لا تقبل أن يكون لدولة تنتهك القوانين الدولية والقانون الإنساني، وآخر قوة استعمارية موجودة في العالم، حق البت في قضايا قانونية في الأمم المتحدة»، فتكفل الرد عليه ديفيد غريسمان، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، حيث قال بحدة: «حتى لليبيا في عهد معمر القذافي انتخب، بالتزكية، رئيسا لهذه اللجنة». وأضاف «نحن بحاجة إلى أمم متحدة تشمل إسرائيل، وتُقرب إسرائيل، لا أمم متحدة تُبعد إسرائيل بشكل منهجي». أما الدول الأوروبية فأثبتت، مرة أخرى، أنها لا تستطيع، الخروج من عباءة السياسة الخارجية لواشنطن، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، إذ يبدو أن إعادة إعمار أوروبا بمشروع مارشال الأميركي ما زال يفعل فعله في استتباع دول الاتحاد الأوروبي، فيما شكلت السياسة «الديغولية» بالاستقلال النسبي عن السياسة الأميركية حدثاً عابراً وانتهي مع نهاية حكم جورج بومبيدو، خلف ديغول في حكم فرنسا.
وأكثر، يبدو أن دول الاستعمار الأوروبي لم تقتنع تماماً بعد بأن التجارب الاستعمارية في التاريخ كان حالها الفشل، أي أنها لم تتعظ، كما ينبغي، لا من دروس هزيمة بريطانيا في الهند، حالها في ذلك حال أميركا في فيتنام وفرنسا في الجزائر…الخ ولا من درس أن نظام الفصل العنصري ضد السود في جنوب أفريقيا قد باد بعد ثلاثة قرون من تطبيقه، ولا من حقيقة أن ثمة لإسرائيل، خلافاً لنظيراتها في تجارب الاستعمار الاستيطاني الإجلائي الاحلالي، معضلتها الخاصة التي لم يحلها إنشائها واعتراف الأمم المتحدة بها، وهي أنها، (إسرائيل)، لم تستطع إبادة الشعب الفلسطيني، كما فعل الغزو الأوروبي مع السكان الأصليين في أميركا قبل نحو ثلاثة قرون، وفي أستراليا قبل نحو قرنين، ولا من حقيقة أن الوطنية الفلسطينية استحالت على الطمس والتذويب أو الاندثار والتجاوز، بعدما تبلورت وتجذرت، كهوية تحررية كفاحية مقاومة، في معمعان قرن من الصراع مع المشروع الصهيوني، و68 عاما مع تجسيده إسرائيل، ولا من حقيقة أن استيطان فلسطين وإجلاء سكانها الأصليين ومنع عودتهم إليها، لم يفضِ إلى التفوق الديموغرافي اليهودي على الأرض الفلسطينية، حيث أصبح مجموع الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية مساوياً لعدد المستوطنين اليهود فيها، ولا من حقيقة أن محيط إسرائيل الإقليمي، والشعبي منه خصوصاً، عربا وغير عرب، يرفضها، ومعاد لها، بينما لم يكن ثمة محيط إقليمي معادي في أميركا وأستراليا المحاطتين بالمياه.
ماذا يعني هذا الكلام؟
صحيح أن التصويت لمصلحة رعاية إسرائيل المارقة للقانون الدولي قد أظهر أن تخلي الأنظمة الرسمية العربية عن واجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية قد بلغ درجة غير مسبوقة، وأن قدرة هذه الأنظمة على التأثير في السياسة الدولية بات صفراً، لكن ذلك، على سوءه، لا يعني، بحال من الأحوال، حلا لمعضلة إسرائيل البنيوية متعددة الأوجه، لا مع الشعب الفلسطيني، ولا مع الشعوب العربية بعامة، ولا حتى مع الشعوب غير العربية في المنطقة. فإسرائيل لا تزال تحلم بانتزاع شرعية إقليمية لم، ولن، تحققها.
وصحيح، أيضاً، أن تولي إسرائيل لهذا المنصب الحساس والمهم الذي لا تستحقه يعني أن النظام الدولي لم يعد يتعامل مع إسرائيل كدولة محتلة، بل كدولة طبيعية. بل، ويعني أن هذا النظام الذي أجبر الأمم المتحدة، سابقاً، على إلغاء قرار اعتبار «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية»، هو النظام ذاته الذي يدفعها، الآن، نحو الانتقال من إلغاء تجريم إسرائيل إلى ترسيم تسييدها، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن شعوب العالم لا تزال ترى في نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا، والذي قاطعه العالم، مجرد مزحة مقارنة بنظام إسرائيل العنصري الإجلائي الاحلالي المُمأسس. ولو كان الأمر على غير هذا النحو لما تعرضت إسرائيل، في السنوات الأخيرة، لحملة مقاطعة شعبية عالمية متنامية وغير مسبوقة، ولما وضعت نتائج استطلاعات الرأي «الغربية» إسرائيل في منزلة أكثر دول العالم خطراً على أمن واستقرار العالم.
قصارى القول: لا شك أن تولي إسرائيل رئاسة لجنة قانونية أممية مهمة في دلالتها السياسية يشكل انتصاراً لها، لكن مكافأتها، وهي دولة الاحتلال المارقة، بهذا المنصب لا يعبر عن مبادئ الأمم المتحدة وقيمها ومواثيقها ومعاييرها المنصوص عليها في نظامها، بل عما يشهده النظام الدولي القائم فيها من مرحلة انتقالية، عنوانها الفوضى وعدم الاستقرار والحروب بالوكالة وإبرام الصفقات بين أقطاب دولية، فواشنطن ما زالت أقوى هذه الأقطاب، بينما روسيا ليست من القوة، (بالمعنى الشامل للكلمة)، بحيث تستطيع تجاوز نظام «القطب الواحد» بشكل كلي. أما الصين، العملاق الاقتصادي والديموغرافي، فتسير بخطى وئيدة نحو التحول إلى قطب سياسي عالمي فاعل. هذا ناهيك أن دول الاتحاد الأوروبي ومعها اليابان، لا تزال تدور فلك القطب الأميركي، وتشاركه في مشاغلة مجموعة «دول البريكس»، ( روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل)، في مشاكل داخلية وإقليمية متعددة الأوجه، بهدف منعها مجتمعة من فرض نظام دولي جديد، أكثر توازنا، سيان: «متعدد الأقطاب» أو «ثنانيء القطبية». أما الأنظمة الرسمية العربية القائمة، فحدث ولا حرج عن انعدام قدرتها على التأثير في الساحتين الدولية والإقليمية، وعن تخليها عن واجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية، بل وافتعال أعداء وهميين للعرب غير إسرائيل عدوهم الفعلي والثابت.