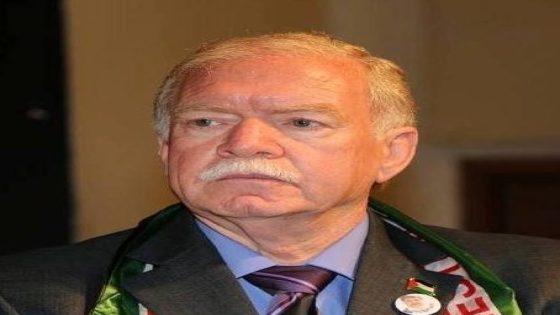عبَّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيراً عن رغبته في تحويل السلام «البارد» مع إسرائيل إلى سلام «دافئ»، مبدياً استعداده للمساعدة في تحقيق هذا الهدف والمشاركة في تقديم الضمانات اللازمة لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية تحيي الأمل لدى الفلسطينيين وتكفل الأمن للإسرائيليين في الوقت نفسه. ولأن التعبير عن هذه الرغبة لم يأتِ مقترناً باشتراط إقدام إسرائيل على تعديل سياستها المعلنة والمعروفة تجاه «عملية السلام»، لتسهيل مهمة الراغبين في التحرك على هذا الطريق، فقد رأت إسرائيل في حديث الرئيس المصري دليلاً جديداً على أن السلام معها أصبح مطلباً عربياً، وأن حاجة الدول العربية لتطبيع العلاقات معها أصبحت أكثر إلحاحاً من حاجة إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، ومن هنا ترحيبها الفوري به.
يدرك كل باحث مدقق في موضوع الصراع العربي – الإسرائيلي أن الحركة الصهيونية كانت تملك منذ اللحظة الأولى لانطلاقها مشروعاً واضح المعالم، يتمثل في إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين التاريخية، وأنها نجحت في حشد وتعبئة طاقاتها ومواردها لتحويل هذا المشروع إلى واقع، ولم تتردد في الاشتباك مع أي قوة تحاول عرقلة سيرها نحو ذلك الهدف. ولأنها كانت تدرك أن ابتلاع فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية في منطقة عربية إسلامية هو هدف يستحيل تحقيقه دفعة واحدة، فقد قررت تبني سياسة تتسم بأكبر قدر من المرونة التكتيكية ومن الصلابة الاستراتيجية في الوقت نفسه، كي يكون بمقدورها قضم وهضم ما تستطيع تحقيقه مرحلياً ثم البناء عليه للتحرك المستمر نحو تحقيق الأهداف والغايات النهائية. وفي هذا السياق يمكن فهم موقف الحركة الصهيونية من قرار التقسيم عام 1947، ومن إعلان قيام اسرائيل عام 1948، ومن حرب «الاستقلال» عام 1948 ثم الحروب «التوسعية» التالية، ومن اتفاقيات الهدنة عام 1949 ومعاهدة السلام مع مصر واتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية…الخ.
ويذكر هنا أن إسرائيل لم تعترف مطلقاً بوجود شعب فلسطيني له قضية يتعين حلها أو له حقوق ومطالب وطنية مشروعة تتعين تلبيتها، ولم توقع حتى الآن على أي وثيقة تعترف فيها بحق هذا الشعب في تقرير مصيره أو في إقامة دولته المستقلة، ولا تزال ترفض أي تسوية تقوم على أساس «حل الدولتين» أو على أساس «دولة موحدة ثنائية القومية»، وأقصى ما قبلت به إما «حكم ذاتي» لفلسطين في الضفة والقطاع، وهو ما نصت عليه اتفاقية الحكم الذاتي الموقعة مع مصر في كامب ديفيد عام 1978، أو الانسحاب من بعض الأراضي الفلسطينية بما يسمح بإقامة «كانتونات» فلسطينية مقطعة الأوصال. بل إن التعنت الإسرائيلي وصل إلى حد المطالبة بحق إسرائيل في المطالبة بالسيادة «تحت الأرض» التي يقوم عليها المسجد الأقصى في أي تسوية تتعلق بمدينة القدس التي تصر اسرائيل على أن تبقى موحدة كعاصمة أبدية لها. كما رفضت إسرائيل تماماً فكرة التفاوض الجماعي مع الدول العربية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع، معتبرة أن لكل دولة عربية على حدة مشكلات مع إسرائيل يتعيَّن حلها عبر مفاوضات ثنائية منفردة. كان هذا هو موقف إسرائيل في مفاوضات رودس عام 1949، وفي مؤتمر جنيف عام 1974، وفي مؤتمر مدريد عام 1991. وحتى مع افتراض أن إسرائيل قد تقبل بالمبادرة العربية الجماعية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 (بعد تعديلها طبعاً)، فمن المؤكد أنها لن تقبل بفكرة التفاوض الجماعي مع العالم العربي وستصر على التفاوض مع كل دولة عربية للبحث في سبل وآليات وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
والواقع أنه يسهل على أي دارس متابع للصراع العربي الإسرائيلي أن يدرك أن إسرائيل لم تسعَ حتى الآن للتوصل إلى تسوية شاملة لهذا الصراع لأن هدفها كان وما زال ينحصر في إدارته وليس حله، والفارق كبير جداً بين مفهوم «إدارة الصراع» ومفهوم «حل الصراع». بل إنني أزعم أن إسرائيل سعت عامدة لإجهاض جميع الفرص التي سنحت للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع، وأنها لم تكن جادة في أي يوم في البحث عن حل لهذا الصراع لكنها كانت حريصة دائماً على إدارته بطريقة تمكنها من إلحاق الهزيمة بالعرب وإجبارهم على قبول تسوية بشروطها هي، أي على الاستسلام.
ففي عام 1953 عبرت الولايات المتحدة، ولأسباب تتعلق برغبتها في إحكام الحصار حول الاتحاد السوفياتي إبان مرحلة الحرب الباردة، عن رغبتها للتوسط بين مصر وإسرائيل للتوصل إلى تسوية، ولم يمانع الرئيس عبد الناصر. ووفقاً للوثائق المتاحة عما جرى في تلك المفاوضات غير المباشرة، يمكن التأكيد أن عبدالناصر بدا جاهزاً ومستعداً لتسوية شاملة تقوم على أساس الحدود الواردة في «قرار التقسيم» مع تعديلات طفيفة لتبادل الأراضي على نحو يسمح بالتواصل الجغرافي بين مصر والمشرق العربي، لكنه لم يكن مستعداً لتسوية منفردة، وهو ما رفضته إسرائيل تماماً.
وفي عام 1977 أقدم الرئيس أنور السادات على خطوة مذهلة في جرأتها، حين قرر زيارة القدس وإلقاء خطاب في الكنيست الإسرائيلي، لكنه لم يحصل في النهاية إلا على «معاهدة سلام» منفرد أخرجت مصر من المعادلة العسكرية للصراع وأحدثت انشقاقاً خطيراً في الصف العربي لا تزال المنطقة تعاني تداعياته السلبية حتى الآن.
وفي عام 1982 حاولت السعودية في قمة فاس العربية، وربما بسبب تداعيات الحرب بين العراق وإيران، إيجاد أرضية مشتركة لتحويل التسوية المنفردة مع مصر إلى تسوية شاملة مع بقية الدول العربية تتضمن حلاً نهائياً للقضية الفلسطينية، غير أن إسرائيل لم تفعل شيئاً لتشجيع هذا التوجه والأرجح أنها تعمدت إجهاضه.
وفي عام 1993 دخل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مفاوضات سرية مع إسرائيل انتهت بالتوقيع على اتفاقية أوسلو، معتقداً أن استعادة «غزة وأريحا أولاً» ستقود حتماً إلى استعادة بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها في نهاية مرحلة انتقالية لا تزيد على خمس سنوات. غير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تكفَّلت بإفراغ هذه الاتفاقية من مضمونها وحوَّلتها إلى «غزة وأريحا أولاً وأخيراً».
وفي قمة بيروت العربية عام 2002 جرت محاولة سعودية ثانية، تكللت بالنجاح هذه المرة، للتوصل إلى أسس مقبولة عربياً لتسوية شاملة، لكن إسرائيل تعاملت مع «المبادرة العربية» بغرور وصلف، وردَّت عليها بمحاصرة عرفات ثم أقدمت على اغتياله، وراحت حكوماتها المتعاقبة تمارس سياسة لا همَّ لها، خصوصاً بعد رحيل عرفات، سوى تحويل السلطة الفلسطينية إلى أداة للتنسيق الأمني، لإجهاض المقاومة المسلحة، وللحيلولة دون اندلاع انتفاضات شعبية جديدة ضد الاحتلال، ولحماية مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة.
يتضح من هذا السرد أن إسرائيل تعاملت في الماضي مع كل تحرك عربي جديد يسعى للبحث عن تسوية شاملة للصراع باعتباره تنازلاً أملاه إحساس بالضعف أو بالخوف، ما يدفعها للتعنت أكثر على أمل الحصول على تنازلات جديدة تدعم استراتيجيتها الثابتة في إدارة الصراع. وأظن أنها ستتعامل بالمنطق نفسه مع التحركات الديبلوماسية الحالية وستسعى جاهدة للاستفادة من حالة الضعف العربية والفلسطينية الراهنة لفرض تسوية نهائية بشروطها. ومن المعروف أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أدلى بتصريحات نشرتها صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر يوم 25 أيار (مايو) الماضي توحي بوجود تحركات ديبلوماسية دولية تستهدف تغيير مبادرة السلام العربية التي تبنَّتها قمة بيروت العربية عام 2002 أكثر مما تستهدف ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول هذه المبادرة. وتضمَّن الكثير من الصحف الإسرائيلية مقالات تحليلية وأخباراً تؤكد أن اتصالات جرت بين نتانياهو وعدد من الزعماء العرب في الآونة الأخيرة، وأن اتفاقاً تمَّ بين أطراف هذه المشاورات للعمل على تعديل مبادرة السلام العربية بما يضمن إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وربما القبول بضم الكتل الاستيطانية، بخاصة في منطقة القدس، الى اسرائيل، مقابل إعلان نتانياهو موافقته من حيث المبدأ على المبادرة العربية بعد تعديلها. واستناداً إلى هذه الأخبار والتحليلات سادَ اعتقادٌ لبعض الوقت مفادُه أن نتانياهو سيقدم على تغيير وزاري يسمح بقيام «حكومة سلام» تضم حاييم هرتزوغ، زعيم المعارضة العمالي، غير أنه فاجأ الجميع بإقدامه على تشكيل حكومة جديدة يشغل فيها أفيغدور ليبرمان، الرجل الذي هدَّد يوماً بضرب السد العالي، منصب وزير الدفاع.
لن أُفاجأ كثيراً إذا خرج من بين ظهرانينا من يحاول تذكيرنا بأن معاهدة السلام مع مصر أبرمها مناحيم بيغن، وأن ليبرمان ليس أسوأ من بيغن، وأن الحكومات القوية هي وحدها التي تستطيع صنع السلام. ويبدو أن المنطقة مقدمة بالفعل على تغييرات ضخمة في المرحلة المقبلة، وهي تغييرات أرجح أنها ستكون أكثر وبالاً على العرب، وبخاصة الفلسطينيين. فهناك من يعتقد، من داخل المنطقة ومن خارجها، أنه آن الآوان لتصفية القضية الفلسطينية، غير أنني على يقين من أن هؤلاء مخطئون تماماً.
* كاتب مصري