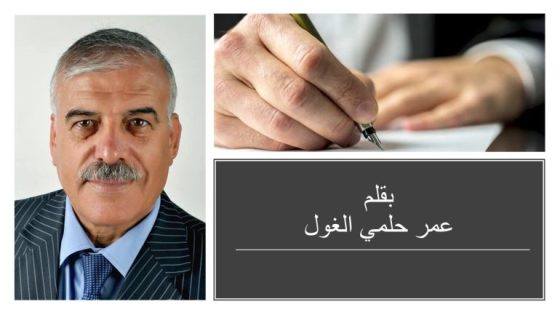بقلم محمود الخواجا
في جسدي معدن دائم، سأكمل حياتي معه، لا يرنّ هذا المعدن عند أي جهاز كشف معادن في أي فندق أو مركز تجاري أو مطار، لا يرنّ إلا عند البقعة الإسرائيلية على جسر الأردن حيث يُضبط جهاز الكشف على عيارات أكثر حزماً.
قبل المرور من تحت الجهاز، أُعلِم العامل البدويّ والمجنّد أو المجنّدة الإسرائيلية المتمركزة مكانها وراء الزجاج:
– “عندي بلاتين”.
فيردّ أو تردّ وهي تصرخ:
– “بلاتينا؟! استنى على كرسي”.
سيضيع إذاً من وقت السفر 10 دقائق، أو 20 أو 30، لست متأكداً، فالوقت خلال الانتظار يمرّ ولا يمرّ، مع تدفّق حمولة باص آخر على الأقل أمام عينيّ، وأنا انتظر. غالباً ما أقضي هذه الفترة بجانب مسنّ أو مسنّة لديهم معدن في مكان ما.
في المرة الأخيرة وفي طريق الإياب، قررت أن “استثمر” فترة الانتظار، وأن لا أشعر بالحسرة لتأخري، أعرف أنني لن ألحظ أمراً مختلفاً، ولكنني سأراقب كلّ ما يحدث ببطئ، وسأعيد النظر في تفاصيل هذا المكان الذي يمرّ منه آلاف المسافرين يومياً، مسرعين ومنهكين في أغلب الأوقات.
في هذا المكان بالذات نتحوّل لآخرين، ولا نستعيد أنفسنا إلّا بعد اجتيازه، في البقعة الإسرائيلية نبدو جميعاً تائهين، تربكنا أصوات المكان، صراخ العامل البدوي في وجوهنا، رنين جهاز الفحص، طَرَقات العبوّات البلاستيكية التي نضع فيها حاجياتنا، دعاوى المسافرين على “دولة إسرائيل”، وعبارات المجنّدين ذاتها:
– “وَلَد.. لَوَرا لَوَرا”، “اشلح كندرة وحط على الجهاز يلا يلا”.
في هذه القاعة، يبدو العامل البدوي، وإن عمل لصالح دولة الاحتلال، أقلّ مكانةً من المجنّدين، ويبدو بالنسبة إلينا قاسياً، وإن كان ابن جلدتنا. قبل أيام مثلاً، صرخت المجنّدة في وجه الفتى البدوي آمرةً إياه برشّ معطّر للجوّ، بعد أن فاحت رائحة أقدام المسافرين، الذين خلعوا أحذيتهم من كل الأعمار، ووضعوها على حزام الفحص، تلبية لأوامر المجنّدين، فيما ظلّ الفتى يبتسم لصراخها.
تتجنّب المجنّدة أثناء انتظاري أن تلتقي عيني بعينها، وإن أشرت بيدي متسائلاً:
– “كم عليّ أن انتظر؟”
ستتصرّف كأنها لم ترَني، وسيسألني زميلها عند الشبّاك الآخر:
– “انت!! بلاتينا؟”
لأحرّك رأسي إيجاباً، متجنباً إشعاره بهزيمتي، في هذه البقعة التي – شئنا أم أبينا – تهزمنا في كل رحلة.
عند هذه البقعة، تتورّم يدا عجوز وهي تحاول خلع أساورها، لأنها ترنّ تحت جهاز الفحص، وتبكي إحدى الفتيات لأنها مرّت من تحته سبع مرات ولا تعرف ما هو المعدن المتبقّي في مكان ما من ملابسها، وسط إلحاح متواصل من المجنّدة والعامل البدوي.
هنا يبتسم المجنّد بلذّة بعد لحظات من صراخه على أحد المسافرين لأي سبب كان، وتضحك المجنّدة مع زميلها بعد عثورها على هاتف كُسرت شاشته، نسيه مسافر آخر.
وفي هذا المكان أيضاً صورة كبيرة لظلال والدين مع طفليهما، يبدون في طريق العودة من سفرهم، وعليها عبارة “ترحيب” كبيرة، في مشهد يبدو مغايراً تماماً لما يحدث من حولنا، خصوصاً في اللحظة التي يبكي فيها طفلٌ بحرقة في آخر الطابور، من عناء السفر.
يصل المجنّد الإسرائيلي أخيراً متحصناً، وبيده عصا كشف المعادن، ويدعوني لغرفة الفحص الصغيرة:
– “وين بلاتينا؟”.. “اشلح بوتك.. فضّي جيابك وحطّه هون”.. “ارفع إيدك”. إلى أن ينتهي الفحص، وأركض مسرعاً لحقيبة الظهر التي سبقتني.
سيرنّ الجهاز في كلّ مرة أمرّ فيها من تحته بعد الفحص، لتصرخ المجنّدة بالنغمة التي حفظناها جميعاً:
– “إرجع.. لَوَرا لَوَرا”.
– “فحصوني”.
– “طيب يلا روح”.
سأكمل طريقي وأنا متأكد من أن هذه البقعة ليست للتأمّل، علينا عبورها دون لحظة توقّف، وفي المرة القادمة سأغلقّ عينيّ وأذنيّ طوال فترة الانتظار. هذا المكان الذي نُعامَل فيه جميعاً كالقطيع لا يناسبنا.
وحين العبور وقبله وبعده، سيلحّ السؤال في ذهني، وأذهاننا جميعاً، “لماذا نسافر في هذا الزمن بهذه الطريقة المتخلّفة.. والمهينة؟ لماذا؟”.
24Fm