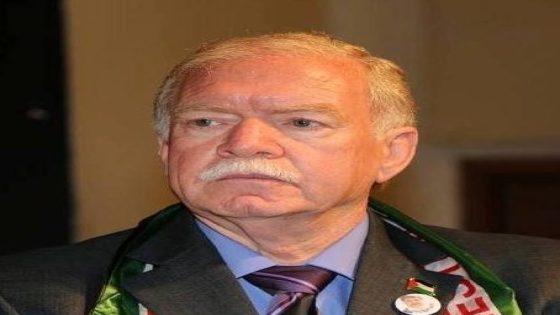عمر الغول-الحياة الجديدة
ما بين الإضاءة والفوانيس التسعة عشر، عشرون إضاءة أشعلها الشاعر والروائي سليم النفار في روايته الأولى “فوانيس المخيم” الصادرة عن مكتبة كل شيء مطلع العام الحالي 2018، وحمل غلافها لوحة للفنان التشكيلي فايز السرساوي. وأبحر الروائي بين دفتي روايته على مساحة 210 صفحات من القطع المتوسط، قص فيها فصلا من حياته الشخصية، عاش تفاصيله بين أزقة مخيم الرمل في الشمال الغربي السوري إلى جانب مدينة اللاذقية الساحلية. الذي ترعرع فيه، وعاش حكايا ومواجع ابناء جلدته من اللاجئين الفلسطينيين، الذين سكنهم حتى النخاع قنديل العودة، ولم يبارحهم لحظة، حتى في أشد لحظات التعثر والتراجع والخيبات، التي عكستها أم علي، وهي تتحدث عن الفرق بين المناضلين والقيادات، وإن كان جمعها بين الكل، ودون تمييز فيه غبن. ثم انتقاله لبيروت وما حمله ذلك من إضافة نوعية لتجربته في النضال الوطني، ومحاولته تبين الخيط الأبيض من الأسود في مسيرة علاقاته بالآخرين في دوائر الزمان والمكان المختلفة.
الرواية الأولى للشاعر المتقد سليم النفار جالت في حكايا ابو صابر وأم صابر (وهما نموذجان لأبطال الرواية، لاسيما ان كل إنسان ورد في الرواية، ساهم بدور البطولة، فكانت البطولة جماعية لأبناء المخيم) وفلوكته، التي جاء بها من يافا لاجئا إلى مخيم الرمل، وحرص المحافظة عليها وصيانتها كل عام دون الإبحار فيها، لأنه نذر ألا يستخدمها ثانية إلا لطريق العودة ليافا ثانية. غير ان نشوب الحرب الأهلية في لبنان والتدخل السوري لجانب القوى الانعزالية، دفع كلاً من محمود وعلي بعد تشييع أخويْ محمود الشهيدين، اللذين شاركا في معارك الدفاع عن الثورة في لبنان، وحماسهما لعكس ايمانهما وخيارهما بالانتماء للثورة. لا سيما انهما كانا انتميا لفصائل الثورة في المخيم، وانطلاقا من رسوخ القناعة عندهما، وعند جميع ابناء المخيمات والشعب الفلسطيني بوحدة الحال الوطني والقومي، انسلا من بين الجموع الحاشدة والمودعة للشهيدين وبرفقتهما سوسن حبيبة خالد، التي غادرت المخيم بطريقة مغايرة لهما حتى وصلت لبيروت، وهما قاما بخطف حلم ابو صابر، وركبا الفلوكة الرابضة على الشاطئ بانتظار ساعة العودة وتوجها لبيروت، وحين علم أبو صابر بعد ثلاث سنوات طوال عمن ركب البحر بفلوكته لم يزعل، لأنهما محمود وعلي مخرا عباب البحر من اللاذقية إلى شواطئ الأوزاعي في بيروت لهدف نبيل، هو الالتحاق بالثورة والدفاع عنها.
وعلي هو ابن الشهيد مصطفى، الذي اضطر مع عائلته، التي كانت تقيم في حي العجمي في يافا قبل النكبة 1948 للجوء لمخيم الشاطئ في قطاع غزة، ثم ابعدته سلطات الاستعمار الإسرائيلي لخارج الوطن، فحط رحاله في بيروت ثم اختار اللجوء لمخيم الرمل في سوريا، وواصل مشوار الكفاح ضد المستعمرين الإسرائيليين إلى ان وافته المنية باكرا قبل ان يحقق حلم العودة. وترك زوجته وحبيبته ليلى مع اطفالها الأيتام يكابدون مرارة الحياة، ورفضت ليلى الزواج من رجل آخر حرصا على ابنائها، ووفاء لمصطفى الشهيد، وغذت فيهم روح الانتماء للوطن والثورة، رغم انها مارست النقد اللاذع لقيادة الثورة نتيجة الأخطاء والسلوكيات غير الإيجابية لبعضهم.
خيوط الرواية متشابكة أولا بين اللجوء وحق العودة، وبين الأجيال العمرية المختلفة، حيث رضع الأطفال والفتيان حليب الحقوق الوطنية في فلسطين وطنهم الأم، التي طرد آباؤهم وأمهاتهم منها، وهذا عكسه جيل الشباب محمود وخالد وسوسن وعلي وعبدالله وفاطمة وفضل العكاوي وغيرهم؛ ثانيا بين صعوبات الحياة والأمل بالمستقبل؛ ثالثا ربط العاطفة والحب بالثورة والانتماء للفصائل الوطنية، كما قصة خالد وسوسن؛ رابعا تنامي دور المرأة في الثورة؛ خامسا الاستياء والغبن من طريقة عمل بعض القيادات المترفة لم يَحلْ دون الانتماء للثورة؛ سادسا الغضب والرفض لخيار وسياسات الأنظمة العربية، نموذجا النظام السوري وعسسه، لم يؤثر على العلاقة بين الشعبين الشقيقين، ولا مع اي شعب من شعوب الأمة العربية، بل العكس صحيح، وانعكس ذلك في الرواية في أنسباء سمير، وجد فضل السوري اللاذقاني، أضف لذلك انتماء المئات والآلاف من ابناء شعوب الأمة العربية للثورة، وتبوئهم مواقع قيادية دون تمييز بين عربي وفلسطيني إلا بالانتماء للثورة والدفاع عنها، وسقوط الشهداء جنبا إلى جنب مع أشقائهم الفلسطينيين في المعارك المختلفة، لأنهم اعتبروا الثورة ثورتهم، وانتصارها انتصار لقضاياهم، والعكس صحيح.
الرواية حاكت فصلا من فصول حياة علي (سليم)، لكنها لامست روح كل فلسطيني وعربي عاش مع الثورة. ولكن خانت الدقة الروائي الحديث اختيار عناوين فصول أو أقسام روايته، فجميعها، وعددها 19 فصلا أو مقطعا بدأها بالفانوس، وحتى استخدم مجازا “الفوانيس الذابلة”، وعلى اهمية استحضار الفوانيس كنقطة ضوء في حياة الفلسطيني، والتسلح بحق العودة، إلا ان المبالغة في استخدامها أضعف حضورها في الرواية، وأصاب القارئ بنوع من عدم الارتياح. أضف إلى ان الرواية بحاجة لبعض الجوانب الفنية، لكن رسالتها الأساسية وصلت، وهي رواية مشوقة كونها ربطت بين التراجيديا المأساوية وبين الدراما العاطفية، وبين التاريخ والجغرافيا، بين الزمان والمكان، وبين الأجيال المتعاقبة ووحدة الحال الفلسطينية ومواصلة مشوار الكفاح التحرري حتى تحقيق الأهداف الوطنية جميعها وفي طليعتها هدف العودة، الذي لا يموت بالتقادم.