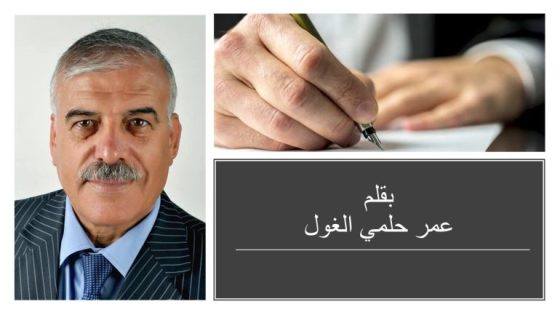دبي – هاني نسيرة
انسحب “التفكير التآمري” في العقل العربي والإسلامي، وفي تجلياته الأيديولوجية والانغلاقية تحديداً، على تفسير أزمات العرب والمسلمين بمؤامرة خارجية.بل وتفسير كل ما يرفضه ولو كان اتجاهاً فكرياً آخر – يلتقي معه أيضاً في مهاجمة الغرب – لكن يحمل صناعته وينسب إنشاءه للغرب أيضاً.
وهكذا يحضر النقد للآخر دائماً دون النقد المزدوج ، ودون النقد الذاتي الأكثر اختفاء وغياباً، ودون الالتحام المطلوب بخطابات وسياقات الظاهرة وتاريخها الخاص الذي أنشأها، قفزاً عليه ونزولاً من علياء المؤامرة الأبدية علينا.
- من القرآن للتاريخ
رفض القرآن توظيف أهل قريش للفكر التآمري أكثر من مرة، في عشرات الآيات التي تلح على المسؤولية الفردية ، وعلى أن “وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ” و”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ”، وأن ظهور الفساد في البر والبحر مرهون “بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ”.
وكذلك في نفي القرآن بالمنطق والحجة لحسم التفكير التآمري في نقض حجة الكفار أن من علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أعجمي!. وحسبنا أن الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لا تنطقان في الخطاب الديني إلا فردية، تأكيداً على المسؤولية الفردية دون استحضار لغير الله أو لأي آخر.
كذلك نذكر التأكيد القرآني على دور إبليس – الذي أقسم عليه في إغواء الناس وإضلالهم، إلا أن الضلال والهداية مسؤوليتان فرديتان، تحاسب عليهما الذات الفرد والأمة دون إلقاء التهمة والجناية على إبليس وحده.
إلا أنه رغم ذلك، ورغم أن عشرات من الأدلة غيرها تؤكد نفي القرآن للنظرة التآمرية ، وتنقض التفكير التآمري الذي لا يصمد أمام الحجة والواقع دائماً – وإن حضر التخطيط والاستهداف من الآخر في أي مسألة – نجد كثيرين يلجأون إلى هذا التفكير.
نعم، على العكس من رفض القرآن النظرة والتفكير التآمري هذا، بدا التاريخ العربي والإسلامي الطويل سلسلة من المؤامرات، منذ النزول من فترة الرسالة وانقطاع الوحي لوقائع التاريخ، فكان تفسير الأحداث الكبرى مختزلاً في تصورات التفكير التآمري الأحادية.
ولقد استمر هذا النمط من التفكير التآمري حاكماً ومحدداً لرؤى كثير من الأفكار المسطحة في عالمنا العربي الحديث لمساراته وتاريخه المعاصر، على مدار القرنين الماضيين، سواء كانت أحداثاً سياسية، كمساءلة فشل المشروع القومي العربي أو مشروع محمد علي الكبير أو مشاريع التنمية التي رفعت هنا أو هناك، أو تفسير الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية – حسب وجهة نظر صاحب الانطباع التآمري – فينسبها للآخر الذي يغيب دائماً، قريباً أو بعيداً، داخلياً أو خارجياً، واهباً وواصفاً له بأنه قوة مطلقة تدير أحداثنا ويظل هو الفاعل الوحيد، بينما نظل المفعول به دائماً.
ولم يقف توظيف التفكير التآمري عند الأحداث السياسية، بل ظل اتهاماً ثابتاً ضد كل الأفكار الإصلاحية والمدنية، من دعوات حقوق المرأة للمواطنة ولحقوق الإنسان والبشر، ولحقوق الأقليات والتسامح والحريات الفكرية، وصماً لها بعار الصنائع الغربية وأنها ليست أكثر من اختراق أجنبي لنا يستهدفنا ويدمر استقرارنا وهويتنا وكل المخاطر الأخرى التي يستنفر بها عناصره وهويته وقواه، لكنه يهرب من المسؤولية أولاً وأخيراً.
- الإرهاب وتوظيف التفكير التآمري
وتوسعت أيديولوجيا التطرف العنيف كل توسع، بحكم أنها أكثر تيارات الهوية انغلاقاً، في استخدام وتوظيف التفكير التآمري اتهاماً لكل أخريها بالعمالة وأنهم جزء من مؤامرة غربية غريبة على الدين وعلى الهوية وعلى الأمة.
ويستمر عنده وصف الأنظمة الحاكمة التي يصفها ديناً بـ”الطاغوت” ويصفها تآمرياً بـ”صنائع الاستعمار” ويصف كل الآخرين المختلفين معه بأنهم “الخونة” حتى ولو كانوا طيفاً من أطياف التصور ومنظومة التطرف العنيف ذاتها.
وقد كتب أبو بكر ناجي – وهو محمد خليل الحكايمة المقتول في أغسطس (آب) 2008 – عن كل المختلفين مع تيار القاعدة والراديكاليات الحركية العنفية – تنظيماً كانوا أو أفراداً – في كتابه “الخونة” ناعتا إياهم بالخيانة، وأنهم علامات أكبر صفقة في تاريخ الحركات الإسلامية قولاً واحداً.
كذلك لا يجد “داعش”، ولم تجد قاعدة العراق، قبله، حرجاً في وصف كل معارضيها أو المختلفين معها، سواء في سوريا أو العراق بالمرتدين…. أو “الصحوات”.
وفي ذلك استحضار لتجربة “الصحوات” الناجحة التي دحرت دولة القاعدة في العراق سنة 2007 وطردتها من عاصمتها في الأنبار، وكان أسسها الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس ولكن أجهضت تجربتها – انطلاقاً من هواجس المؤامرة والطائفية – حقبة نوري المالكي الذي تركها كلأ مباحاً للقاعدة في العراق التي وضعتها على رأس استهدافاتها قبل قوات الشرطة والقوات الأميركية وغيرها انفراداً بالمشهد السني.
وهو ما نجحت فيه بشكل واضح قبل عام 2011 وساعدها ودفعها في سياقات ما بعد الانتفاضات العربية بشكل كبير، حتى تكون متفرغة بشكل كامل لهدف “التمكين” وليس فقط “الاستنزاف” وإقامة إمارتها ودولتها المزعومتين، بل وادعاء خلافتها التي تصر على بيعة الآخرين لها دون اعتراض وإلا القتل والوصم بالخيانة كذلك.
كذلك لم يألُ “داعش” كثيراً من الجهد في جدله الساخن والشديد مع “القاعدة” وفصالهما الشديد في أبريل (نيسان) 2013 في اتهامها بالمؤامرة والخيانة، فهما يخونان بعضهما.
- هل «داعش» مؤامرة؟
إن أي نظرة بانورامية سريعة لظاهرة “التطرف العنيف” ، كما يمثلها “داعش” – المشارف على السقوط – أو «القاعدة»، التي تحاول التمدد في هذا الانهيار واستعادة قيادتها وصدارتها لمشهد “الجهاد” العالمي، أو أخواتهما من الجماعات والمجموعات، يجد أن التفسير والتفكير التآمري في الظاهرة غالب وسائد عند الكثيرين، وأنه تم اصطناعها لإرهاق الأنظمة والمجتمعات ليس غير، ولكن تتجاهل هذه النظرة أن عداء هذه الجماعات المتطرفة للغرب موجود وحاضر ومستمر كذلك، سواء عبر خلاياها النائمة وعملياتها كما يتجاهل عوامل ونواقض أخرى لها حاضرة دائماً.
وقد يشترك مع التآمريين العرب في هذه النظرة غربيون يؤمنون كذلك بفكر المؤامرة، شاع وذاع بعضهم منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، التي لا يزال بعضهم يصر على أنه قد فعلتها الولايات المتحدة بنفسها، وأنه لم يفعلها الإرهاب القاعدي الذي لا يزال يقسم على فعلها.
ومع أنه أثبتت التحقيقات وجود دور للنظام الإيراني في هذا، وتتالت الشهادات من عناصر القاعدة فخراً به، فإنهم يصرون على الحكومة الخفية في العالم، وعلى افتراض قدرة كلية تصنع كل شيء تجاوزاً للتفاصيل والحقائق الواضحة.
ختاماً، نرى أن نقد «داعش» أو جماعات التطرف العنيف انحباساً في النظرة التآمرية للغرب وللعالم، رغم أن ارتباكات الإدارة الدولية في الفترة السابقة، وخصوصاً في الحقبة الأوبامية كانت جزءاً من رفد حضوره في المنطقة بعد الانتفاضات العربية.
إلا أنها ارتباكات وليست مؤامرات، وعمليات «داعش» في أوروبا وعواصمها، فضلاً عن خطابها وتوجهاتها والحرب المشتعلة عليها الآن، يعني تجاوز التاريخ وصناعته كما يستريح الهارب من المسؤولية فقط.
كما أن اختزال حالة وظاهرة ضخمة من التطرف العنيف والتشدد غير العنيف في صناعة الآخر، يعني فشل الذات وعجزها في آن عن مكافحته، وهو ما ينبغي أن نحرص على عدم التورط فيه والانزلاق إليه.